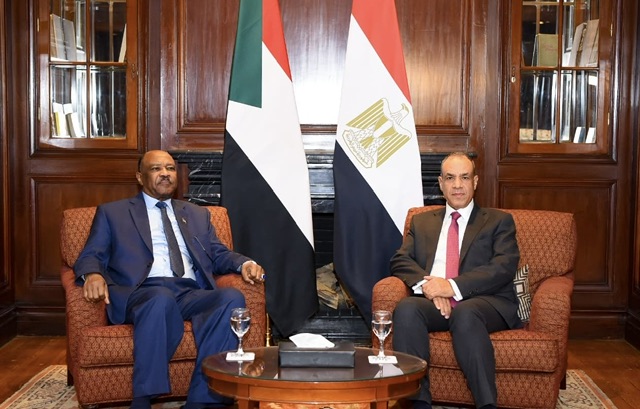نفسك تعمل فيها بطل؟ أنت حر. قالها لي ونحن، أنا وهو، داخل حجرة عتيقة من حجرات التحقيق في سجن القلعة الشهير. كنت واقفًا أمام مكتب يجلس هو وراءه، تتناثر عليه بعض الأوراق والملفات، أحدها بغلاف أقرب إلى الصفار، مكتوب عليه: "رئيس المجموعة"، لم أتشرف من قبل برؤية وجهه الكريم، فضلًا عن أن الإضاءة في الغرفة مركّبة بطريقة تلقي الضوء كله في عيني، وتتركه هو في بؤرة من الظلام.
ومع ذلك، صوبت عيني في عينيه، وهو يشير إلى الصور المعلقة على الحائط الشائه خلفه. قال لي وهو ينظر في عيني: تعرف أصحاب هذه الصور؟ تعجبت في نفسي من السؤال، ولم أحرّك ساكنًا. قال: هذه صورة عبد الناصر، وهذه صورة السادات.
وتابع يقول: أنا زيك ناصري، لكني عايزك تفهم حاجة واحدة. عبد الناصر جاء ومضى، والسادات جاء وسوف يلحق به، وتبقى السلطة هنا. نظرت إلى حيث يشير، فوجدته يشير إلى نفسه. فهم نظرتي بذكاء ثعلب، وقال: لا أقصد نفسي، إنما أقصد الجهاز. أمن الدولة. نحن السلطة الحقيقية. من يتعامل معنا يربح، أما هؤلاء الذين يتصورون أنهم يصنعون بطولة، فهم الخاسرون. شوف انت بقى... عايز تعمل بطل؟ أنت حر.
كانت تلك من أوائل القضايا التي جرى فيها التعذيب في عهد أنور السادات.
من اللحظة الأولى في معتقل القلعة، غطّوا أعيننا بقطعة قماش سوداء نتنة الرائحة. وحين بدأت حفلات التعذيب الليلية، كانوا يعلّقوننا على الأبواب وأيدينا مربوطة من الخلف، حتى ارتخت عضلات أحدنا، إذ إن وزنه وطوله ثقُلا على يديه، فانقطعت أحبال عضلاته، ولم يعد قادرًا على تحريك يديه، ارتختا إلى جانبيه كأنما انفصلتا عن جسده.
أسوأ ما عانيته في تلك الحبسة، وفي غيرها، أن ضابط أمن الدولة كان يتعامل مع المتهم السياسي باعتباره مذنبًا لمجرد أنه صاحب رأي مخالف للحكومة.
أذكر أن أحدهم ظل يشتمني ويشتم أمي بأقذع الألفاظ وأحطّها، وأنا معصوب العينين، عاري الصدر، مربوط اليدين إلى الخلف، أقف أمامه بلا حول ولا طول.
سألته والدم يغلي في عروقي: هل تعتقد أننا في خصومة شخصية؟ ما الذي بيني وبينك حتى تَفْجُر معي ومع غيري كل هذا الفُجر في التعامل البذيء؟
لم يعد ذلك الضابط للتحقيق معي، ولا استُدعيت بعدها إلى غرفة التحقيق في سجن القلعة، حتى خرجنا منه إلى سجن الاستئناف، فكأنه الإفراج.
كل أولئك الضباط خرجوا من الخدمة، وأصبح نقد بعضهم لهذا النظام الذي تفانوا في الدفاع عنه، أشد من أي نقد وجّهه معارض غُيّب من قبل في غياهب السجون، أو عُلّق فوق الأبواب، أو سُبّت أمه وأبوه بكل بذيءٍ من القول.
أعرف واحدًا منهم ظل يتحسر حتى مات على كل ضربة قلم، أو شتيمة بذيئة، في حق مواطن كانت تهمته الوحيدة أنه يحب البلد على طريقته.
رئيس المجموعة التي حققت معي في معتقل القلعة دانت له الدنيا، وشرب من كأس السلطة حتى ارتوى، فأصبح وزيرًا للداخلية. ولأنها لا تدوم، خرج من السلطة وصار إلى ما صار إليه.
ثم شاء حظي أن أجلس معه لاحقًا، في معية أستاذنا الكبير محمود السعدني، في نادي الصحفيين على النيل. كان بقية رجل، بلا حول ولا طول، يتحسر على أيامه الماضية.
ثم جاء عليه وقت، صار فيه يرتجف من زيارة ضابط صغير بأمن الدولة، يحذّره من نشر بعض فصول مذكراته في جريدتنا. فامتنع، وهو يعتذر منا وجلاً: أنا رجل مريض، ولا أريد أن تكون آخر أيامي بهدلة. أنا عاوز يا ابني أموت على فراشي، وبين أسرتي، ولا أريد مشاكل مع أحد.
دارت اليوم برأسي كل هذه الذكريات، كأنها جرت بالأمس القريب، رغم مرور أكثر من خمس وأربعين سنة.
وما يزال السؤال يتردد داخلي:
لماذا تتعاملون مع الناس وكأنكم في خصومة شخصية معهم؟
لماذا تنسون أن يومًا قريبًا سوف يأتي، يحاسبكم فيه الله والناس على كل هذه الجرائم؟
ساعتها، لا تنفع الحسرة، ولن تشفع لكم دموع الندم.
----------------------
بقلم: محمد حماد